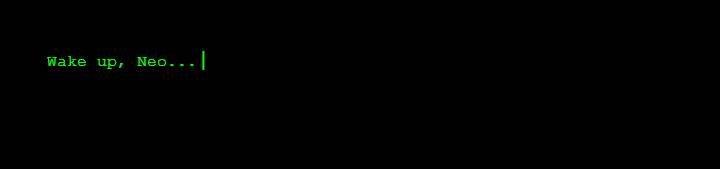النقر على جدران الذات: محاولة لِفَهمِ شيفرة الداخِل
وقال لي: قِف بحيثُ أنت.. واعرِف نَفسَك !
– المواقف: موقف بيته المعمور، النَفريّ
من غفلة الضياع إلى لعنة اليقظة
في مرحلة الضياع الأولى، ظلّ “نيو” Neo في فيلم المصفوفة The Matrix يبحث عن الإشارات الخَلَاصية، بعدما كان إنسانًا عاديًا مُنهمِكًا في مستنقعٍ ضَحلٍ، يُدعى: الحياة اليومية.
كان “نيو” تافهًا، بالرغم من أنّ تفاهته هذه كانت تمنحه الطمأنينة والاستقرار، لأنّ الحياة اليومية تخضع لقانون التكرار والرتابة، وهو شيء يمنح الأمانَ الخارجيّ، لكنّه في الوقت نفسه، يُكثّف الفراغ الداخليّ.
فجأة يتلقّى نيو رسالة على شاشة حاسبه: “نيو.. استيقظ”
هذه المرحلة تحديدًا ما سنسميها (الورطة الوجودية) وهو ما يحدث حين تعي شيئًا جديدًا، لَم يكن بالحسبان. السبب الرئيسيّ لـ (الورطة الوجودية) هذه، هو (الوَعي) والوَعي غالبًا ما يأتي على هيئة تعرية الذات من أوهامها، أو ما يحدث حين نستيقظ فجأة من بعد الغفلة والانهماك.
كان ابن القيّم في مدارج السالكين قد وصفَ (اليقظة) بأنّها (انزعاج) حين عرّف اليقظة بقوله: هي انزعاج القلب، لروعة الانتباه، من رقدة الغافلين. واللافت هنا وصف ابن القيّم لليقظة بـ “الانزعاج” تمامًا مثل الصحو من النَوم، ومثل الاستيقاظ من حلمٍ كاذب، انزعاج لأنّك في لحظةٍ ما أدركتَ أنّ الذي كُنتَ تعيشُ فيه لَم يَكُن إلّا وَهمًا وغفلة. حتّى لو اتّخذ شكلُ غفلتك السابقة أشكالًا عدّة بإسم الحرّية والتحرّر والتقدّم والانفتاح، فكلّ ما يُسيطر على أصالتك وعلى عفويتك وعلى قدرتك على عدم الانخراط بما هو شائع، هو بحدّ ذاته استعباد لذاتيتك ولو سمّى نفسه حرّية.
إنّ (خِداع الذات) قد يوفّر قدرًا من الراحة المُؤقّتة، لكن حين تسوء الأوضاع نتيجة صدمة أو فقد عاطفي، ستنهار عوامل الأمان المُؤقّتة والحياة المُتوهّمة. وما نسمّيه بـ (الأزمة الوجودية) هو شعور الفرد بأنّه لا يمكن لأحد أن يحميه من مواجهة الحياة. إنّ حجم الانهيار النفسيّ الذي يحدث للإنسان عند فقدان وظيفة أو فشل علاقة عاطفية يتناسب طرديًا، مع مقدار خداع الإنسان لذاته. وبالتالي ما نراه كإنهيار أو أزمة وجودية، هو فشل الفرد في خداع ذاته (الإنكار، الكبت، السخرية..) أمامَ حقيقةٍ صارخة أو كارثةٍ لا يُمكن تجاهلها.
لذلك فإنّ الأزمة الوجودية: هي هذه المرّة التي لا تنفعكَ فيها حِيَلَك القديمة، ولا إجاباتك الجاهزة. وما لا تستطيع إنكاره أو تجاهله أو تشتيت نفسك بالانشغال عنه. إنّ الإزمة الوجودية، هي ما تضطّر لابتلاعه دفعةً واحدة دون أن تستطيع هضمه أو تفتيتَ زخمه، وما لا تستطيع الامتناع عنه بإغلاقِ فَمِك، إنّها تلكَ اللُقمة الإجبارية من مائدة الحياة. إنّها تلكَ الوجبة التي إمّا أن تستوعبها فتنضج أو تتقيّأها فتظلّ تائهًا في غياهب الوهم.
عند هذه النقطة تحديدًا يملكُ الإنسان خيارًا ما، كما قال صاحب العلاج بالمعنى من قبل، حتّى السجين داخل السجن، يملك خيارات متعدّدة لكيفية قضاء وقته داخل هذا السجن (أحدهم ينتحر، وآخر يصيرُ أكثر تديّنًا، وآخر يتدرّب فيصيرُ رياضيًا، وغيرهم يُدمِن المُخدّرات). لا يملك الإنسان أن يمنع نكبات الحياة ومصائب الدهر، لكنّه يملك أن يمتصّ الصدمات بحكمة، وأن يستثمرها لإنضاج ذاته، أو أن يستوعب النكبة كضحيّة مع بقائه في وضعه الأوّلي بعد الصدمة. في الحالة الأولى يتعامل الإنسان معَ نفسه كمحارب يخوض معارك عدّة، ينتصر بأحدها ويخسر بأخرى لكنّه لا ينهزم وفي كلّ مرّة يكون قد صاغَ نسخة أفضل من نفسه.
أمّا الحالة الثانية فهي حين تقرّر أنّ الأزمة التي تمرّ بها ليست ذا شأن فتتجاهلها أو تنكرها أو تكبتها في داخلك، أو أن تسخط دون أن تخوض رحلة مراجعة ذاتية لكلّ الأوهام التي أحطت نفسكَ بها، وناتج هذه الحالة أن تبقى حيث كُنتَ، من قبلُ ومن بعد، أنتَ حيث أنت.
وأمام ثقافة عالمية تتمركز حول صناعة الضحايا، والترويج لفكرة الضحية بوصفها هُويّة وحيدة للاعتراف، فإنّنا سنقع في فِخاخٍ كثيرة وأوهامٍ عديدة إذا ما سمحنا لأنفسنا أن نتعرّف على أنفسنا بوصفنا ضحايا للخارج أو ضحايا لما يفعله الآخرون بنا. هذا كلّه قد يصحّ لدى العديد من الأفراد، لكنّه لا يصحّ لفئة أخرى مغايرة، فقد كان نيتشه على مقدرة عالية على كشف ألاعيب الذات وأوهامها، وكان الدرس الأهمّ الذي ينبغي أن نتعلّمه، إذا كان من خطرٍ حقيقيٍّ يتهدّدنا، فإنّه ولا شك سيكون من الداخل. فأخطر الأكاذيب هي تلكَ التي نُوجّهها لأنفسنا، وأدوى سقوط سيكون حين تتكسّر أوهامك الذاتية، لا أوهامك الخارجية.
هذا يُعيدنا إلى “نيو” هذا المَلعون الذي حلّت عليه لعنة الصحوة، “نيو” الذي تورّط وجوديًا من الخارج، ففي المجلس الذي جلسه مع “مورفيوس”، أخرج “مورفيوس” حبّتين اثنتين، أحدها حمراء وأخرى زرقاء، تأخذ الزرقاء أخبره مورفيوس، فتنتهي كلّ هذه القصّة، كل هذا العنف الوجوديّ وكلّ هذا الصخب الحَربيّ للحياة، وقال: تستيقظ في فراشك، وتؤمن بما تريد الإيمان به أنّى كان.
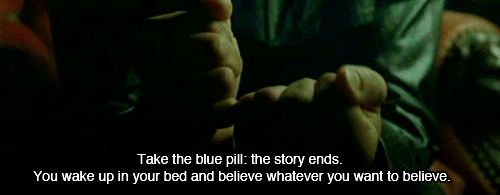
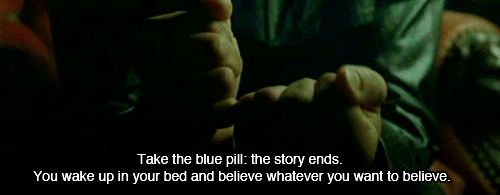
عند كلّ أزمة تمرّ بها، تملك خيار أن تعود لأوهامك، أن تعود لسَريرِك، أن تؤمن بما كُنتَ تُؤمنُ به سابقًا، أن لا ترى في نفسكَ أيّة مشكلة، فكلّ ما يجري لكَ من أذى هو من الخارج بطبيعة الحال، أمّا أنتَ فلا شيء يُعيبك، لَم تُخطئ، أنتَ كما أنت، ضحية لغدر الآخرين وفريسة لنوائب الدهر، إذ أيًّا كان التبرير الذي نتّخذه لأنفسنا، فإنّ أي تبرير يفي بالغرض، وكفيل بإبقائنا على قيد الحياة. لذلك فإنّ أخطر ما في الإنسان، هو قدرته الدائمة على تبرير نفسه، إذا فهمتَ هذا، ستعرف أنّه لا حدود للأفعال التي يمكن للإنسان أن يقوم بها، بحجّة مبرّرات كثيرة لا أساسَ لها، لكنّها تعمل بشكلٍ جيّد بطبيعة الحال.
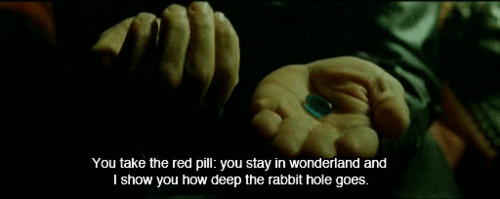
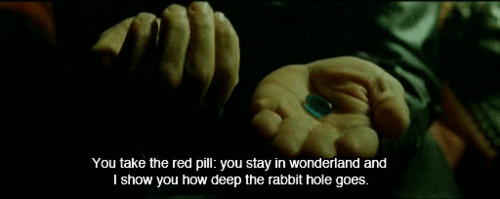
تأخذ الحبّة الحمراء، يقول “مورفيوس” للمسكين “نيو”، فتظلّ في أرض العجائب، وحينها سأُريك عُمق الحفرة. فكما أنّه لا حدود لقدرة الإنسان على تبرير نفسه، -وهذه مهارةٌ إبليسيّةٌ بامتياز- فإنّه لا حدود للإمكانات التي يقدر الإنسان على إطلاقها من ذاته، إذا ما أراد في كلّ مرّة أن يسمح لنفسه بالنماء والاتّساع. إذ ينضج الإنسان في كلّ مرّة يتمكّن فيها من احتمال تناقضاته، وهي عملية تستلزم الشجاعة في أصلها، وهكذا فإنّ الوجود بغير شجاعةٍ ولا مسؤولية، يؤول إلى العدم والغفلة والضياع. فالدّرس البليغ الذي تُقدِّمه لنا الحياة في تقلّباتها وتجاربها:
ما لا تذهب إليه بكاملِ شجاعتك، سيُطاردُكَ كفريسة
وما لا تذهب إليه بإرادتك، سيأتيك قاهرًا إيّاك
والأشياء لا تختفي لمُجرّد رفضكَ النظر إليها
وما ترفض أن تذهب إليه بفضول، سينهشُكَ كصَدمة
وكثرة التصلّب أمام واقعٍ شديد التغيّر، سيتسبّب بتحطيمك
هكذا تسير الأمور أحيانًا
أحيانًا نكون مُوزَّعين بين اختيارين، ونَجد أنفُسَنا قد انجرفنا في طريق.. ثُمّ يُسلّمنا هذا الطريق لقرارٍ جديد.
وهكذا.. بعدَ عام، نجد أنفُسَنا في مكانٍ لم نُخطِّط إطلاقًا أن نصلَ اليه.
أحيانّا نتراجع، لكنّنا معظم الأوقات لا يُمكننا فعل ذلك.. فنُواصِل التقدَُم.
وبعدَ عشرينَ عامًا.. ننظر خَلفنا ولا نتذكّر أصلًا لماذا فعلنا هذا كلّه.
― عزّالدين شكري فشير، عناق عند جسر بروكلين
تجربة الوجود: قلق الحرّية ومعضلة البحث عن القرار الصائب


في الفيلم العظيم، “السيّد لا أحد” Mr. Nobody يقف الطفل “نيمو” (بطل الفيلم) في محطّة القرار مُمسكًا بأيدي والدَيه، وهي أقدم نقطة لوَعي “نيمو” بذاته من حيث إجباره على ممارسة حرّيته منذ سنٍّ مُبكّرة، فهو يقف على مفترق الطُّرُق وعليه أن يختار بأن يُكمِل حياته مع أمّه أو أبيه، وكما هو معلوم لحضرتك عزيزي القارئ، من السهل أن تختار بين شيء تحبّه وتكرهه، لكن ماذا تفعل حين يجب عليكَ أن تختار بين خيارَات متكافئة من حيث الرغبة والصحّة؟
بحسب علم النفس الوجوديّ، تُطاردنا في حياتنا على الدوام أربع مخاوف وجودية:
• الخوف من الحرّية
(أن تخشى أن تفقد السيطرة على حياتك)
• الخوف من المَوت
(أن تعرف أنّ ما يمضي لَن يعودَ أبدًا)
• الخوف من الوحدة
(أن تُدرك أنّك في نهاية المطاف، تواجه هذا الوجود وحدَك)
• الخوف من الفراغ
(أن تخشى أن تفقد قدرتَك على تعريف نفسك)
إنّ الموقف الذي تعرّض له نيمو في محطّة القطار، يمثّل حالة نادرة يتعرّض الإنسان فيها في لحظة زمنية ضئيلة لزخم المخاوف الوجودية الأربع دفعةً واحدة، ولذلك ظلّ نيمو، طوال حياته عالقًا عند هذه اللحظة بوصفها لحظة غير قابلة للتجاوز، يُعطينا فيها ثلاثة مبادئ عامّة عندما نقف على مفترق الطرق:
• طالما أنّك لَم تَقُم بالاختيار بَعد، فإنّ جميع الخيارات تظلّ مُمكنة ومتكافئة
وهذه العبارة، تنتمي إلى المصدر العميق للقلق: الخوف من الخطأ وذُعر ممارسة الحرّية، الخوف من تحرير طاقة الوضع الكامنة أو فقدانها لصالح طاقة الحركة. فالسكون بلا حراك لواقع نعرفه -ولو كان سيّئًا- يُعدُّ خيارًا آمنًا وأكثرُ رحمةً من رُعب المجهول الممكن. إذ يطمئنّ الإنسان للأشياء الثابتة في حياته حتّى وإن كانت سيّئة ومؤذية. ويخشى النّاس التغيير، لأنّه مجهول ومُقلِق وإن كان القادم أفضل وأجمل. يُحبّ الناس أن تبدو عوالمهم منطقية ومتناسقة، ومن هنا.. فإنّ كل تغيير جديد مُقلِق ومُربِك. أو كما يقول طمّليه: البارحة أجمل، لأنّنا نعرفها.


• كلّ خيار في المُحصّلة هو خيار صحيح بأثَرٍ رجعيّ، إذا كُنّا على استعداد لأن نتعلّمَ الدّروسَ الكامنةَ فيه
إذا تجاوزنا الصواب والخطأ الأخلاقيّ، فإنّ كلّ قرار بالنهاية هو قرار صحيح، وسيَعبُر وإن كان قرارًا خاسرًا أو سيّئًا، وستكون قصّته حينها أنّه قرار سيّء، لكنّه يظلّ صحيحًا من حيث إمكانه كخَيَار. ينتمي هذا المبدأ إلى الخوف من أن نفقد القدرة على إيجاد المَعنى في اختياراتنا. إذ لا أحد يُحبّ أن يقول لكَ أنّ ما أفنى حياته فيه، لا معنىً له، الكلّ سيُخبرُكَ قصّته كما لو أنّها مُكتملة الأركان، فالنّاس لا تفصل بينها وبين تجاربها، وحين تخبر أحدًا ما أنّ تجربته خاطئة أو فاشلة، فما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني فشله هو كذات. لذلك فإنّ النّاس تخشى من أن تصيرَ أسرى لخيارات خاطئة أو حياة خاوية من أيّ مَعنى.


• لَيس بإمكانك العودة إلى الوراء، ولهذا تجد صعوبة وجودية في كلّ مرّة يجب أن تقرّر فيها أو أن تختار
تنتمي هذه القاعدة إلى الخوف من المَوت، تحديدًا من مَوت الماضي، وعدم القدرة على استعادة اللحظات الماضية، وهو نفسه ما يتشكّل على هيئة الخوف من النسيان، الخوف من الاندثار، الخوف من أن نصيرَ ماضٍ ككلّ الأشياء الأخرى. والأساس الفيزيائي لهذا الإدراك البشريّ، العُقدة التي تشكّلت في وَعينا البشريّ حين أدركنا سَير الزمن الحتميّ نحو الأمام، والذعر الذي يخلقه إدراكنا أنّ الزمن دائمًا يقهرنا وأنّه خارج سُلطتنا وسيطرتنا، وأنّه لا يعبَأ بنا ولا بتطلّعاتنا نحنُ الكائنات الفانية.


لكنّ “نيمو” قد تنبّه لهذا مُتأخّرًا، إذا كان هذا واقع الحياة، فلماذا لا نستثمره لصالحنا؟ لماذا لا نُوظّف هذه المآزق الوجودية في تخليق المعنى من وجودنا؟ كيف؟
بالحُبّ والإرادة. فإذا كان الزمن يتقدّم في مسارٍ حتميّ نحو الأمام، فلماذا نقاومه؟ لماذا لا نحجز لنا فيه ذكريات ثابتة للأبد، أمسكَ بيدها وقال: أحبّ هذه الفكرة، بأنّنا في زمانٍ ما، في مكانٍ ما، قد كُنّا سَويًّا، لحظة زمنية خالصة لنا، وحدَنا، للأبد! بهذا تجاوز “نيمو” الذعر الذي يخلقه وَعيه بسطوة الزمان عن طريق توظيف الحتمية الزمنية إلى أداة لتخليد وتثبيت الذكريات الصادقة والجميلة للأبد.
أمّا عن سطوة ذعر الحرّية والخوف من الوقوع في الخطأ، فقد كان الرعب الحقيقيّ في تهالك زوجته التي تدخل دوّامةً من الاكتئاب المُتتالي ومحاولات الانتحار التي لا تنتهي، قالت له: إذا بقيتُ معكَ هُنا، فإنّك ستغرق مَعي، سأسحبُكَ نحو القاع! كانت معضلةً وجودية أخرى وكان سيتعاظم دور الرجل الانسحابيّ الكامن في الداخل، لولا أنّ “نيمو” كان قد تجرّأ وتخطّى خوفه من الحرّية، فأجابها: لا بأس! سنتعلّم السباحةَ معًا.
عودةً للسؤال الأوّل: ماذا تفعل حين يجب عليكَ أن تختار بين خيارَات متكافئة ومتساوية من حيث الرغبة والصحّة؟
بحسب هندسة المواد الساكنة Statics: إنّ الأجسام تكون ساكنة، حين تكون محصّلة القِوى الواقعة عليها تساوي صِفرًا، أي أنّنا كبشر نصير عالقين وساكنين بلا حراك، حينما نجدُ أنفُسنا مشدودين باتّجاهات متعاكسة بنفس المقدار من القِوى. وقد يكون نفس المقدار من الرغبة أو نفس المقدار من الكراهية أو نفس المقدار من الألم.
هكذا تصير ذاتك موضوعًا لمُحصّلة القِوى، وحين يكون ناتج القِوى التي تتجاذبك تساوي صفرًا، فإنّكَ تظلّ واقفًا وعالِقًا في الوَسَط بلا حراك. يحدث هذا حينما نكون مُبَعثرين من الداخل، وحين نجدنا نَميل إلى كلّ الخيارات بنفس الطريقة، مشدودين إلى جميع الاتّجاهات، وحين تكون كلّ الخَيَارات المُتاحة أمامنا، خَيَارات مؤلمة أو مَرغوبة. يُشبه هذا ما يحدث في لعبة الشطرنج، وهي حالة تُسمّى Zugzwang حينما تكون مُكرهًا على اتّخاذ خطوة خاسرة، فتبقى عالقًا بلا حراك.
تبدو الحياة بمُجمَلها كما لو أنّها وَرطة إجبارية أو فوضى من الخيارات التي لا تنتهي. لقد جيءَ بِكَ إلى هُنا، في زَمَنٍ مُحدّد ومكانٍ مُحدّد. لَم يكُن قدومَك إلى هنا، قرارك الشخصيّ. أمّا الطريق فإنّه مليءٌ بالمخارِج والأسهم الإرشادية على رأسِ كُلّ مُفتَرَقٍ من الطُرُق. فلسفات عدّة وتنظيرات متعدّدة وأنتَ وحدَكَ عالقٌ هنا، تنهشكَ الحيرة. كان “غيورغي غوسبودينوف” الشاعر والكاتب البلغاري في روايته الكثيفة “فيزياء الحزن” قد قال شيئًا مماثلًا حين قال: إنّنا مصنوعون من متاهات.. الأمر الأكثر كآبة في المتاهة هو أنّك دومًا في حالة اختيار. ما يُربكك ليس غياب المَخرَج وإنّما: وَفرةُ المخارج.
لقد تقرَّر في مكانٍ ما ، أن تنبثق من رحم هذه العائلة الطيّبة، ذات الموجودات التي كانت قد تورّطت بهذا كلّه من قبل. مقدار شفقتك على نفسك يتناسب طرديًا مع قسوة الحياة وبرائتِكَ الداخلي. تنظر في عين أهلكَ تارةً فترى اعتذراهم لكَ يتوارى خلف نظراتهم. عن ماذا يعتذرون؟ يتساءَل الطيّبُ الآخر.. عن الإتيان بك، وعن توريطك بهذا كلّه، على الأقلّ إقحامك بهذا المكان الملعون المَدعو وجودًا، يقول الشيطان الذي يختبئ خلف التساؤلات. وأمام فخ الوجود هذا، أتذكّر أنّ بول إيلورا قال ما معناه، أنّ أحدُنا لا يُمكنه أن يتخيّل واقع الحياة، دون أن تمتلئ عيناه بالدموع.
تدخل في مرحلة التيه أو الضياع، لكن ما المشكلة في أن نتوه وجوديًا؟ تكمن الخطورة في حالة التيه، أنّك تصير فريسة سهلة لإغواءات كثيرة، أيّ أنّك في محاولة تعويضك عن الشعور بالفراغ والضياع، تبدأُ تلتهمُ بشراهة كلّ تجربة تساعدك على الامتلاء المُؤقّت، هذا يعني أنّك لا تنظر فيما تريد حقًّا، لأنّك تائهٌ بالأساس، وحين تكون تائهًا ولا تعرف ما تُريد فإنّ كلّ الطرق ستؤدّي الغرض في نهاية المطاف. فقد قالت الفيلسوفة والمتصوّفة “سيمون فايل” من قبل: كلّ مَعصية، هي مُحاولة لتعبئةِ فراغٍ ما.


حين تتوه، تصيرُ عبدًا لأولئك الذين يعرفون طُرُقَهم، يُشبه هذا إلى حدٍّ بعيد تيه بني إسرائيل، في مرحلة التيه تجدُكَ تعبدُ كلّ عِجلٍ له خوار، أي له جاذبية أو غرائبية أو غموض ما تكتنفه تجربة عبادته، لكنّك تنسى هذا وتصيرُ تعبدُ ما يعبده النّاس، لأنّها تجربة ممتعة بطبيعة الحال، أن تكون رواقيًا أو بوذيًا أو لا أدريًا أو مُنحلًّا من أيِّ قيمةٍ أخلاقية، لكنّك تنسى في مرحلة التّيه أنّك بحاجة إلى نبيّ لا إلى صَنَم، إلى موسى لا إلى العِجل. إنّك بحاجة إلى رسولٍ يُرشدُكَ إلى الصواب وإن كان صعبًا، لا إلى تجارب تُشعرُكَ بالّلذة وإن كانت آمنة. إنّك بحاجة إلى مَن يُريكَ أخطاؤُكَ لا إلى مَن يُؤكّد لكَ عيوبَك.


وبدلًا من أن تتحمّل مسؤولية إنقاذك لذاتك، بدلًا من أن ترى طُرُقَ الأنبياء، تصير عبدًا للأصنام الجاهزة مُسبقًا، وخاصّة تلكَ التي لا تُملي عليكَ أيّ مسؤولية أخلاقية حيال نفسك وحيال الوجود من حولك، فالعِجل هو رمزية لكلّ صنم مُزيّف يُغريكَ وتعبده عند ضياعك، سواء أسمّى نفسه: عدمية، سخط، لا مبالاة، لذّة، غموض، إدمان، فلسفة، شُهرة. وقد تُدرِك هذا مُتأخّرًا فتجدُكَ صرتَ عبدًا للضياع وصرت تخشى أن تجدَ لنفسكَ طريقًا يُعرِّفكَ أو تُعرِّف نفسكَ من خلاله.


وللأسف.. فإنّ (مفترَق الطُرُق) هذا، يهاجمنا كثيرًا ويقتحم استقرارنا الداخليّ، أكثر من عدد المرّات التي سِرنا فيها إليه، بكامل إرادتنا. لكنّنا ننسى كيف وصلنا إلى هذا كلّه، ننسى اللحظة الماضية حين هاجمتنا حيرة طارئة، لَم يكن قد حان وقتها بعد، حيرة مُبكّرة، شيء أشبه بالابتزاز الوجوديّ، كان عليكَ حينها أن تختار الآن وهنا. في هذه الّلحظة تحديدًا قد تختار، وقد تضيع وتدخل مرحلة التّيه، أو قد تظلّ عالقًا أو قد تقرّر ألّا تختار، وهو ما سيطلق عليه الآخرون لاحقًا: النهج العدميّ. وهو شكل آخر للاحتجاج على ابتزاز الحياة لنا بضرورة الاختيار.
تكمن المشكلة في أنّنا حين نختار، نختار غالبًا اختيارات صغيرة، علاقة عشوائية، فرصة بسيطة، رفض عفوي، لكن ما يحدث في حقيقة الأمر، هي أنّ هذه القرارات الصغيرة، تضعنا في مسار، هكذا الأمور وبكلّ بساطة، كلّ قرار مهما كان صغيرًا يضعنا في مسار جديد، وكلّ مسار جديد يضعنا أمام سلسلة جديدة من الاختيارات وهكذا، ما يبدأ كاختيار عفوي ينتهي بنا إلى فوضى معقّدة من المسارات.
(أنا إنسان لأنّني أُخطِئ) كما يقول ديستويفسكي على لسان أحد شخصياته، وبدون أن نتحلّى بالشجاعة الكافية للوقوع بالخطأ، فإنّنا سنظلّ أسرى للأماكن الآمنة ولأوضاعنا الابتدائية Status Quo، وعبيدًا مُخلصين لأصنام الطريق التي تُغرينا في مراحل التّيه والضياع. أمّا المؤمن فهو الكادح كدحًا إلى الله، والذي يتحرّر من أصنام الطريق لأنّه يعرف أنّ إلى ربّه المُنتهى.
كلّ الناس يَغدو.. فبائعٌ نَفسَهُ فمُعتقها أو مُوبِقُها
― الرسول الكريم: محمّد -صلّى الله عليه وسلّم-
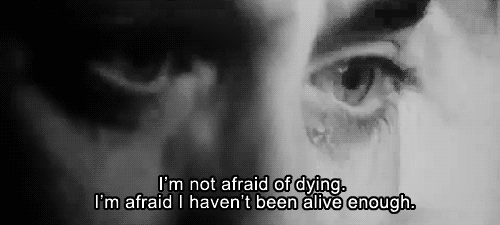
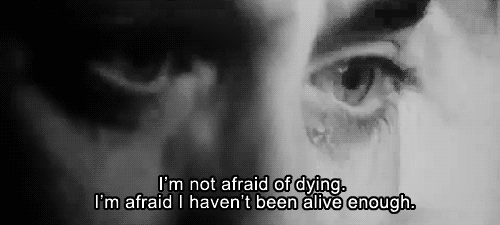
بحسب علم النفس الجشطالتي، فإنّ هناك ثلاث حقائق رئيسية يتمركز حولها أيّ فهم صحّي للوجود:
أولًا: الأشياء كما هي في حقيقتها لا كما نُريدها أن تَكون
تبدأ هذا النُقطة المركزية من حقيقةٍ مُؤلمة، حين نتقبّل فكرة أنّ الأشياء هي كما هي، ليس كما أُريدها أن تكون، ولا كما يجب أن تكون، ولا كما تعوّدنا منها أن تكون. هذه النقاط على بداهتها أساس لكلّ اضطراب نفسيّ حين لا نتقبّلها. فالواقع الخارجيّ والمجتمع الخارجي الآن يُشكِّل واقعه الحاليّ بكلِّ سوئه وقُبحه وآلامه، ولا جدوى من إنكار ذلك، ولا طائل من التسلّف عبر تخيّل عوالَم ماضية خلت أو عبر محاكمة الأشياء بقوانين صلبة كانت تحكمها في الماضي، إذ يظلّ كثير من كبارِ السنّ عالقين عند كيفية ما مِن سير الأمور، في ظنّهم أنّها الطريق الأصوب والأكثر صحّة، لكنّ إقامتهم في الماضي المُتخيّل تَحول دونَ أن ينسجموا مع واقعهم ويتسبّب لهم بأنواعٍ عُصابيةٍ شتّى.
معظم الأشكال العُصابية لرفض الأشياء يأتي من مَقولة ضمنية بما يجب أن يكون، مثل أنا غير سعيد لأنّي “يجب أن أكون..” أو النّاس كريهين لأنّهم “يجب أن يكونوا..” أو الواقع حقير وسوداوي لأنّه “يجب أن يكون…” كلّ مشاعرنا بالخوف أو الخجل أو الخيبة تأتي من افتراضاتنا الصلبة تجاه الأشياء، لأنّنا نعتقد أنّها يجب أن تتكيّف وأن تتطابق مع واقعها في أذهاننا.
هذا يشمل ذاتي أنا، ذاتي الآن هي كما هي الآن وعليّ أن أُواجه نفسي وأن أتقبّلها كما هي، بعُيوبها وقُبحها وجمالها، وهذا لا يعني أن أُبقي على عيوبها، ولكن أن أعترف بذلك وأن أتخطّاها بالضرورة. وذاتي الآن ليسَت كما كانت، وليسَت كما أتمنّى، وليسَت كما يتمنّى الآخرون، وليسَت كما ينبغي أن تكون. وبدون إدراك واقع حالي في هذه اللحظة سأظلُّ مشدودًا لمُتخيَّل لا يجيء، ولماضي لا يعود، وهكذا سأظلّ في محاولة غير مُنتهية لمَلئ كأسٍ لا قاع له.
الآخرون كذلك كما هُم الآن لا كما تتمنّى منهم أن يكونوا. ينضج المَرءُ كثيرًا ويتقدّم إلى الأمام خطوات، حين يَعي حقيقة فكرة مفادها أنّ: الآخر ليس أنا! لا يُفكِّر كما أُفكِّر، ولَم ينشأ بنفس الظروف التي نشأتُ بها. الآخرون ليسوا كما أتمنّى بل هُم أبناءُ تجاربهم وبيئاتهم ونشأتهم، الآخرون مهجوسون بهمومهم ورغباتهم، وهذا لا يعني أنّها يجب أن تُطابق رغباتي وهمومي.
وهذه التعقيدات كلّها تحول بينَك وبينَ فهمكَ إيّاهم، لذلك لا أحد يُعاني كما يُعاني شخص يظنّ أنّ بإمكانه أن يقرأَ أفكار الآخرين، أو أن يتوقّع ما يُفكّرون به، وأن يُخمِّن رغباتهم ومخاوفهم، لأنّه سيقع في فخّ عنيف حين يتصرّف معهم على هذا الأساس ويُحاكمهم بناءً على توقّعاته الخاصّة والشخصية، ولأنّه مُتيقّن أنّ بإمكانه أن يعرفَ ما يجري في ذهن الآخر، حقّ المعرفة.
[ أنا.. ما تريدُ منّي أن أكون ] كما يقول بيراندللو. افتراضاتك المُسبَقة عن الأشخاص، تحول بينك وبين فَهمِهم أو رؤيتهم على حقيقتهم.
أنا انعكاس لما تتوقّع.
أنا أبدو لكَ كما ترغب أنتَ.
أنا هو ما تريد منّي أن أكون.
ولذلك حينما تُحبّ أحد، سترى كل تصرّفاته جميلة، وحينما تكرهه لن تُرضيك كلّ محاولاته لتحسين صورته، إذ بعض التصنيفات موجودة في رؤوس الآخرين فقط لا غير، إنّها طريقتهم لفَهمِك وتفسيرك. لذلك حين يقول لَك أحدٌ ما.. أنتَ شخصٌ جيّد، فهذا غالبًا لأنّك تسير وفق الطريقة التي يتوقّعها منكَ بالأساس، أو لأنّك توافق توقعاته ورغباته وأفكاره. وحين يقول لكَ أحدٌ ما.. أنتَ شخص سيّء، فهذا غالبًا لأنّك لا تسير بالطريقة التي يريدها أو يتوقّعها منك. أو لأنّك لا تؤمن بما يؤمن به.
لذلك فالحبّ الصحّي والناضج هو ذلك الذي نتقبّل فيه الآخر كما هو، ويتقبّلنا فيه نحن كما نحنُ، دون محاولات إكراهه بشكل غير واعي وغير ناضج أو تسلّطي باتّجاه إعادة صهر ذاته وتشكيل شخصيته وفق المُتخيّل الذي في رؤوسنا، وإلّا لِمَ قبلتَ بتوريطه معكَ مُنذ البداية لو كان كلّ ما تريده ليس الآخر ولكن.. المُتخيّل الذي في رأسِك.
ثانيًا: ليسَ هُناك شَيء طيّب، تحصل عليه بلا ثَمَن
إذا كان هُناك شيءٌ جديدٌ سيتحقّق.. فلا بُدّ من أن تدفع ثمنًا ما مُقابل الحصول عليه، فكلّ قرار باتّجاه شيءٍ ما، هو قرار يُعاكس تّجاهًا آخر. وكلّ ما تحصل عليه، عليكَ أن تدفع ثمنه، فأحيانًا يكون ثمنه باهظًا وأحيانًا يكون رخيصًا، وأحيانًا يكونُ ثمنه رمزيًا أو شعورًا مُربِكًا. لكنّها طاقة وضع.. يجب أن تخسرها، لكي تُتيح المجال للشكل الجديد من أشكال الطاقة (الحركة أو طاقة وضع أخرى) المهم أنّ الثمن دائمًا موجود، وإن كُنتَ لَم تلحظه بعد، إذ ليسَ هُناك شيء جديد تحصل عليه مجانًا بلا ثمن، بلا شعور، بلا خسارة.
لا يعني هذا أنّك يجب أن تدفع المال في كلّ مرّة، فلو كان الأمرُ يقتصرُ على المال فحسب، لكانت الأمور غاية في السهولة. لكنّنا ندفع أشكالًا أخرى دائمًا، أكان وقتًا، أم اهتمامًا أم علاقة أم رغبة أم منصب، فحين تُقرّر أن تُؤسّس عائلة جديدة، فهذا لأنّك تخسر عائلتك الأولى ولو رمزيًا، وحين تُقرّر أن تُكمِل الدراسة في الخارج فهذا لأنّك تقرّر أن تتخلّى عن وطنك، وحين تقرّر أن تجني مزيدًا من المال عبر بذل المزيد من الجهد، فهذا لأنّك تدفع الثمن من صحّتك، وهكذا فإنّ كلّ قرارٍ باتّجاه ما، هو قرار يُعاكس الاتّجاهات الأخرى.
كلّ حقّ يُقابله واجب أو مسؤولية، كلّ اكتساب يُقابله عطاء، كلّ زيادة يُقابلها نقصان، لكي لا يختلّ ميزانكَ الوجوديّ، ما يُضافُ إلى جانبٍ ما، يُنتَقصٍ من جانبٍ آخر، وما يستتبع الإيمان بهذه النقطة، هو أن ننضج وجوديًا وأن نتجاوز المرحلة الطفولية في فهم الحياة، التي نتوقّع فيها أن يمنحنا الآخرون ما نتمنّى لمُجرّد أنّنا نتمناه أو نطلبه، وأن نتجاوز أن نتوقّع من الحياة أن تمنحنا ما نُريد لمُجرّد رغبتنا به، دون أن نبذلَ جُهدًا ودون أن ندفع الثمن.
خورخي بوكاي المُعالج النفسيّ الأرجنتيني، له استعارة جيدة عن كُلَف التغيير، يقول فيها: “إذا أردتَ الطيران، فعليكَ أن تخلق فراغًا في المكان الذي تقف فيه، حتى تتمكّن من بَسطِ أجنحتك” وخلق الفراغ الذي يقصده، يعني خسارة شيء ما من الوَسَط القديم، إبعاد وإقصاء مَوجودات أصلية لخلق مساحة. إذ ليس هُناك شيء طيّب، تحصل عليه بلا ثَمَن. إذا أردتَ الانتقال ستخسر، وإذا أردتَ التقدّم، فعليكَ أن تتقبّل فكرة أنّك ستخسر باستمرار. إذ ليسَ الشأنُ توقّف الخسارة، لكن اختيار ما أنتَ على استعداد لخسارته.
ثالثًا: لا يُوجَد إنسان بإمكانه أن يفعَل كلّ ما يريد فعله، لكنّ كلّ إنسان بإمكانه أن لا يفعل أبدًا ما لا يُريد فعله
يجب ألّا أفعل أبدًا.. ما لا أُريدُ فعله. لا يُمكنكَ تحقيق كلّ ما تتمناه، لكنّك على الدوام بإمكانك أن لا تفعل ما لا تُريد فعله، يمكن للنّاس أو للحياة أن تحرمكَ ما تتمنّاه، لكن لا يُمكِن لأحد أن يُجبِرُكَ على فعل شيءٍ لا تُريد فعله. أيّ أنّنا لا نملكُ حقّ امتلاكِ ما نُريد دائمًا، لكنّنا دائمًا نملكُ حقّ الرفض. إذا كُنتُ راشدًا وعاقلًا فإنّه لا يُمكِن لأحد أن يُجبرني على فعل شيء لا أرغب به. لا تفنِ نفسَكَ فيما لا تُحبّ، ولا تكن عبدًا لطُرُقٍ تكرهها.
هناك ثلاث أنواع من الحقائق:
• حقائق صلبة كالصخور.. كي تبني منزلكَ فوقها
• حقائق عميقة كالمحيط.. تكتشف معنىً جديدًا في كلّ مرّة تغوص فيها
• حقائق ساطعة كالنجوم، لتكون دليلَك في كلّ مرّة تتوه في سَفَرِك